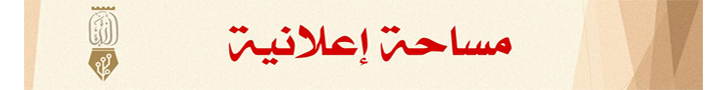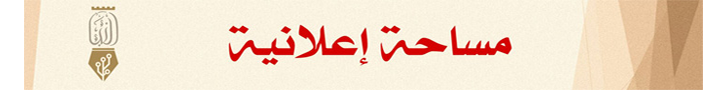الإدارة من المنظور الإسلامي (2/3)

د. طالب بن خليفة الهطالي
خلال السنوات الأولى من الدعوة، اعتمد النبي ﷺ على مركزية القرار، حيث كانت جميع المهام، بما فيها التشريع، والتنفيذ، والقضاء، تتم تحت إشرافه المباشر. لم تكن هذه المركزية مجرد ضرورة تنظيمية، بل كانت استراتيجية لإرساء الثقة في القيادة وتوحيد الصفوف، خاصة أن الدولة الإسلامية كانت في بداياتها وتعتمد على الاستقرار الداخلي لتثبيت أركانها.
في هذه المرحلة، كانت المدينة المنورة مركز الحكم، ومنها كان النبي ﷺ يدير جميع الشؤون، بما في ذلك تعيين القادة، وتنظيم العلاقات الدبلوماسية، والتخطيط العسكري، وإدارة الموارد المالية. ومع ازدياد عدد المسلمين واتساع الدولة، بدأ النبي ﷺ بتطبيق نظام تفويض الصلاحيات، حيث أرسل الولاة والرسل إلى الأقاليم، وأوكل إليهم مهام نشر الدعوة، وتطبيق الشريعة، وتسيير شؤون الناس. ومع ذلك، ظل هؤلاء القادة الإداريون مرتبطين بالخلافة المركزية، التي احتفظت بالقرارات السيادية العليا مثل التعيين، النقل، وإعلان الحرب.
فمع وفاة النبي ﷺ، واصل الخلفاء الراشدون تطوير النظام الإداري بما يتلاءم مع توسّع الدولة، فاعتمدوا نظاما إداريا متوازنا يجمع بين المركزية واللامركزية، حيث احتفظت العاصمة بالقرارات السيادية، بينما تم تفويض المهام الإدارية للأقاليم. فقد شهدت خلافة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- استمرار النهج الإداري الذي وضعه النبي ﷺ، حيث بقيت المدينة المنورة العاصمة السياسية والإدارية، بينما تم تقسيم الدولة إلى سبع ولايات هي: (الحجاز و عُمان والبحرين والعراق والشام واليمن وأخيرا مصر) وقد تم تعيين ولاة ذوي كفاءة عالية لإدارة هذه المناطق، بما يحقق التوازن بين الاستقلالية المحلية والارتباط بالحكم المركزي، وهو نهج يوازي مفهوم الإدارة الفيدرالية الحديثة.
شهد فترة خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قفزة نوعية في التنظيم الإداري، حيث قام بتقسيم الدولة إلى وحدات أصغر وأكثر تخصصًا لضمان الإدارة الفعالة.
تم تقسيم الولايات الكبرى إلى أقاليم أصغر، مثل:
• العراق: الكوفة والبصرة
• الشام: دمشق وفلسطين
• فارس: ثلاث ولايات
• شمال إفريقيا: ثلاث ولايات
وقد عزّز عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من آليات الرقابة والمساءلة الإدارية، حيث كان يراقب أداء الولاة ويرسل المفتشين لمتابعة تنفيذ السياسات العامة، مما يمثل نموذجًا مبكرا لمفهوم الحوكمة الرشيدة. فقد كان من أبرز الإنجازات الإدارية خلال هذه الفترة تطبيق مبدأ فصل السلطات، حيث احتفظ الخليفة بالسلطة التشريعية، بينما أسندت السلطة التنفيذية إلى الولاة وقادة الأقاليم، مما ساعد على منع تداخل المهام وضمان المساءلة الإدارية. وقد تم إدخال أنظمة رقابية صارمة لمتابعة أداء المسؤولين، وهو ما يعكس تطور مفهوم الرقابة الحكومية الحديثة.
لم يشهد عهد الخليفتين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- تغييرات جوهرية في التنظيم الإداري، حيث استمر العمل بالنظام الذي وضعه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. ومع ذلك، ركّزت هذه الفترة على تعزيز الاستقرار الإداري، وإدارة التحديات السياسية والاجتماعية التي بدأت تظهر نتيجة توسّع الدولة.
إن النموذج الإداري الإسلامي لم يكن مجرد إطار تنظيمي بسيط، بل كان نظاما متكاملا يجمع بين المرونة والكفاءة، والتخطيط الاستراتيجي، والحوكمة الرشيدة. فمن خلال الموازنة بين المركزية واللامركزية، وتفويض الصلاحيات، وفصل السلطات، وتعزيز الرقابة والمساءلة، استطاعت الدولة الإسلامية إدارة شؤونها بكفاءة رغم التحديات الجغرافية والسياسية. ويُظهر التحليل أن مبادئ الإدارة في الإسلام تتقاطع مع أحدث النماذج الإدارية الحديثة، مما يعكس رؤية متقدمة في التنظيم المؤسسي وبناء الحكم الرشيد، وهو ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به حتى في سياقات الإدارة المعاصرة.
ويُعد النظام الإداري الإسلامي نموذجا متكاملا يجمع بين المرونة والكفاءة، حيث استطاع النبي ﷺ والخلفاء الراشدون وضع أسس تنظيمية تتسم بالاستدامة، والتكيف مع متغيرات الزمن، وتلبية احتياجات الأقاليم المختلفة، مع الحفاظ على وحدة الدولة وارتباطها بالمركز. ويمثل هذا النظام الإداري أحد أقدم النماذج التي دمجت بين الأخلاق والسياسات الإدارية الفعالة، حيث يقوم على مبادئ مثل تفويض الصلاحيات، والتخطيط الاستراتيجي، والرقابة الإدارية، والتوازن بين المركزية واللامركزية. إن دراسة هذا النموذج بعمق تكشف كيف يمكن تحقيق إدارة رشيدة ومستدامة، تلبي احتياجات الحاضر وتواكب تحديات المستقبل